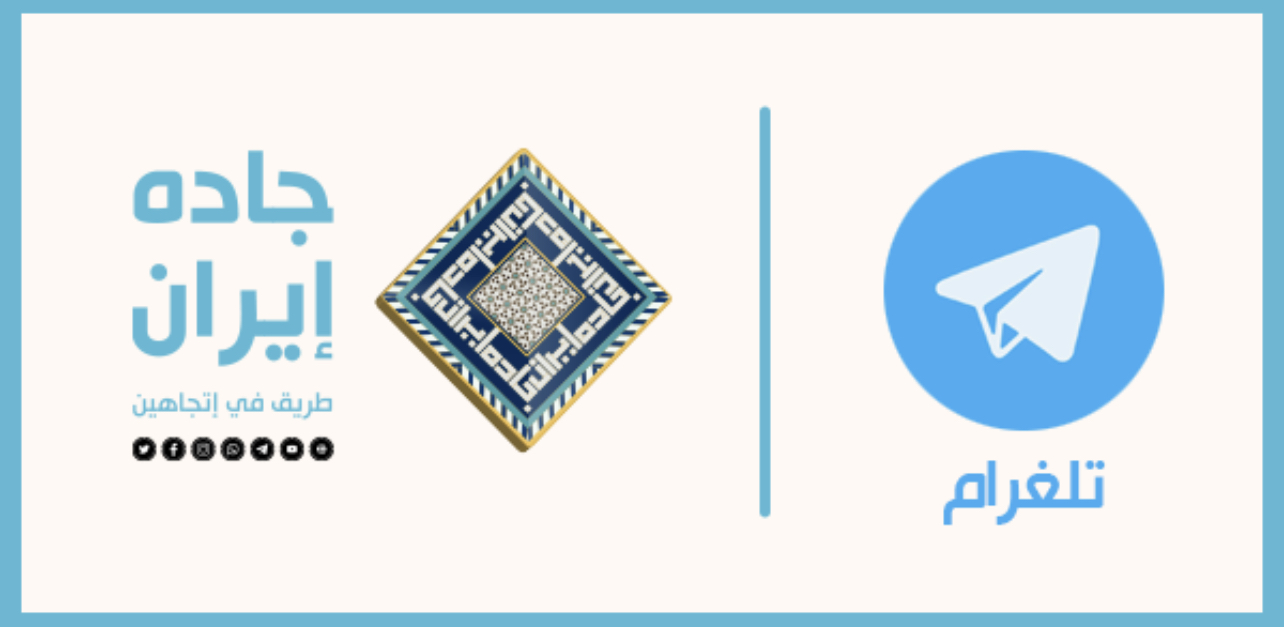جاده ايران- ترجمة/ ديانا محمود
رسول برويزي (١٩١٩- ١٩٧٧ ) قاص إيراني من مدينة بوشهر الجنوبية، حظيت مجموعته القصصية “السراويل المرقعة” على شهرة واسعة، ابتعد عن عالم الأدب لصالح السياسة، لكن قلمه احتفظ بمكانته بين رواد الجيل الأول للقصة للقصيرة الإيرانية اخترنا لكم قصته الشهيرة “حكاية نظاراتي”.
حكاية نظاراتي /الجزء الأول

تعيش هذه القصة في ذاكرتي وتلمع كالشمس في عتمتها و تستطع مضيئةً كالنهار، وكأنها وقعت منذ ساعات قليلة، فهي حتى الآن تحتل أول الزوايا في ذاكرتي.
بقيتُ حتى الصف الثامن وأنا أظن أن النظارات كالعصا وربطة العنق، أشياء إفرنجية يضعها الرجال على عيونهم للزينة، فخالي ميرزا غلام رضا الأنيق دائماً والمهتم بمظهره الذي كان يرتدي سروالاً ضيقاً وربطة عنق باريسية ويواكب صرعات الموضة بشكل منتظم حتى إنه حاز على لقب “مسيو” في مدينتنا كان أول رجل آراه مرتدياً للنظارات، حب خالي الشديد لتلميع الأحذية وتناول الطعام بالشوكة والسكين وغيرها من الحركات الغربية، جعلتني أعتقد جازماً أن النظارات شيء حداثي ويوضع على العيون للتجميل فقط.
تذكر هذه القصة وتعال معي إلى المدرسة التي كنت أدرس فيها، كنت أطول من أبناء جيلي نسبياً، أمي -حفظها الله- كانت تشتكي دائماً عندما تشتري لي ولأخي ملابسنا وتعيد علينا مثلاً شعبياً : “أخوان أطول من راية يزيد”، تطولان وكأنكما تريدان جلب الحساء من السماء!، لكنني مع كل هذا الطول لم أكن أرى بشكل جيد، لم أكن أدرك ذلك، ولأنني لم أكن أرى السبورة بشكل واضح كنت أمضي نحو المقعد الأول دائماً، وكما تعلمون جميعكم فقد كنتم تلاميذ فإن المقعد الأول للأولاد الأقصر. وهذه المشكلة كانت مشكلة صفنا، ومحور مشاجراتي الدائمة مع الآخرين، ولكني كنت شقياً شريراً بعض الشيء والمساكين زملائي القصار والسمان كانوا يهربون مني خوفاً من العراك معي بعد الصف. لكن الموضوع لم ينتهي هنا، ففي أحد الأيام استقبلني معلمٌ أناني مدلل بصفعة أمام باب المدرسة دوى صداها في كل أنحاء الباحة، أمسكت خدي وعيناي تقدحان من شدة الغضب، أفرغ المعلم بوجهي ما في فمه من شتائم وصرخ قائلاً: “مابك هل عميت؟ أم أنك ابن الآغا؟ ترى معلمك في الحي ولا ترمي السلام عليه؟!”
تبين لاحقاً أن الأستاذ مرّ بالقرب من حيّنا ورآني ولم أرمي السلام عليه، وظن أنّي أتكبر وأتطاول على مقامه فأدبني اليوم منتقماً.
الوضع في المنزل لم يكن أفضل، فغالباً ما كنت أتعثر بالأواني عندما كنت أنهض عن سفرة الغداء أو العشاء، فأكسر الأقداح وينسكب الماء هنا وهناك، ودون أن يدرك أحد إنني نصف أعمى يغضب الجميع فيشتمني أبيّ وتهزأ مني أميّ وتقول: كالجمل غير المروض تعفر بقدميك دون أي ذوق، أنظر أمامك ربما هناك حفرة ستقع بها.
لسوء حظي أنا نفسي لم أكن أعلم أنني نصف أعمى، فكنت أظن أن الجميع يرون بنفس المستوى!
ولهذا كنت أتحمل الشتائم، وكنت ألوم نفسي لأتحرك بدقة أكثر!، ما هذه الحالة؟ دائماً تتعثر قدمك بالأشياء وتسبب لنفسك المشاكل. أما مشكلتي الأخرى فكانت في لعبة كرة القدم، فلم أتمكن من التقدم والتطور في هذه اللعبة أبداً، كنت أرفع قدمي مثل بقية الأولاد وأركز على التسديدة وأركل الكرة، لكن قدمي كانت لا تصل إلى الكرة ، فامتعض ويضحك الأولاد وتُجرح كرامتي.
أسوء مشهد أتذكره كان في ليلة لعروض السحر وكان هناك شخص يشبه غلام حسين المشعوذ، جاء من شيراز، وجاءت جموع البشر من نساء وأطفال ورجال لمشاهدته وكانت صالة العرض هي صالة مدرسة شابور، وأعطاني المشرف بطاقة دخول مجانية، منحت للطالب الأول والثاني، كنت أطير من شدة الفرح، وعند المساء ذهبنا إلى العرض وحصلت على مكان في آخر الصالة، بدأت أمعن النظر في المسرح، وضغطت جفني محاولاً النظر بدقة أكثر، أعتلى الخشبة أحدهم وأخرج منديلاً وبدأ اللعب، كل من كان حولي كان ينظر مشدوهاً ويتعجبون أحياناً ويضحكون أحياناً أخرى ثم يعلو التصفيق، وأنا أصغّر عيني أضغط جفوني دون فائدة، فقط أشباح غير واضحة،لم يكن باستطاعتي فهم ما يحدث كيف وماذا، فاعتلاني الحزن والألم، أخذت أسال من حولي: ماذا يفعلون هناك؟ وكان الجواب إمّا الصمت أو التعجب مع جملة هل أنت أعمى؟. أدركت في تلك الليلة أنني مختلف عن بقية الأولاد، لكني لم أحدد ما هي مصيبتي ، نعم ينقصني شيء، طاف بي الحزن يومها وامتلأني الوجم مع تلك المشاعر.
للأسف لم يدرك أحد مصيبتي، ولم يساعدني أي شخص، كل أخطائي كانت بسبب عدم الرؤية ولكنهم كانوا يضعون اللوم عليّ وعلى كسلي وإهمالي، وأنا أيضاً كنت أوافقهم الرأي.
على الرغم من إننا سكنّا في المدينة منذ مدة، إلا أن منزلنا مازال ذا طابع قروي، فمثل تلك الأيام التي كنا نسكن فيها بالميناء، فجأة يأتي إلينا عشر أشخاص من البادية مع أحصنتهم وجمالهم وبغالهم ويضعون مراسيهم في منزلنا عدة أيام، كذلك هي الحال هنا في شيراز. وعلى الرغم من أن أبي لم يعد ميسور الحال إلا إنه لازال سخياً كعادته، صحيح أن بيتنا وكل أثاثه أصبح رهن السماسرة إلا أن الضيافة والكرم لا حد له. كل من يأتي من الجنوب يعرج علينا، رحم الله أبي كان صدره رحباً جداً وصاحب نخوة لا توصف، يبيع ساعته ليكرم ضيفه، في إحدى الليالي جاءتنا ضيفة عجوز من كازرون تنشد الأغاني للنساء وتقرأ الأدعية وفي العيد تغني وكانت مبدعة مميزة في عملها وصاحبة لسان جميل كما أنها تروي القصص والسير. وجميع الأطفال يحبونها فعندما تحل ضيفة علينا يحل السرور وتقضي الليالي وهي تروي لنا الحكايا وأحياناً تغني لنا ونحن نصفق فرحاً، لم تكن تخجل من أحد تقول كلمتها مباشرة دون مواربة فتقول عيوب الناس في وجههم، أمّي كانت تحبها جداً، فهي أولاً مثلها من كازرون وأهل هذه المدينة متعصبين لبعضهم الآخر، ثانيا كانت تقف إلى جانبها وتلوم أبي دوماً لأنه تزوج عليها؛ باختصار كانت ضيفة محبوبة.